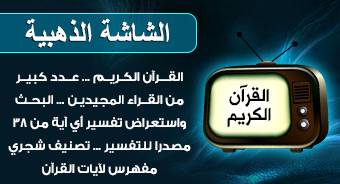|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: دلائل الإعجاز **
تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب وأولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد. ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلاً ويظهر فيه مزية. وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً وتعجباً وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت من صاحبتها على ما هي موسومة به حتى يقال إن رجلاً أدل على معناه من فرس على ما سمي به. وحتى يتصور في الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون هذا أحسن نبأ عنه وأبين كشفاً عن صورته من الآخر فيكون الليث مثلاً أدل على السبع المعلوم من الأسد وحتى إنا لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية ساغ لنا أن نجعل لفظة رجل أدل على الأدمي الذكر من نظيره في الفارسية. وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية أو أن تكون حروف هذه أخص وامتزاجها أحسن ومما يكد اللسان أبعد وهل تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها. وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه: قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم. وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقاً للتالية في مؤداها وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: " فتجلى لك منها الإعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع! أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقريها إلى إن شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية قل: ابلعي واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم في أن كان النداء ب يا دون أي نحو: يا أيتها الأرض. ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماء ثم اتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها ونداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها. ثم أن قيل: وغيض الماء. فجاء الفعل على صيغة فعل الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر. ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى: " ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو " ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن. ثم مقابلة قيل في الخاتمة ب قيل في الفاتحة. أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب فقد اتضح إذاً اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة. وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في بيت الحماسة من الطويل: تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتاً وأخدعا وبيت البحتري من الطويل: وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. ثم إنك تتأملها في بيت أبيى تمام من المنسرح: يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة. ومن أعجب ذلك لفظة الشيء فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ومن مالىء عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى وإلى قول أبي حية من الطويل: فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول. ثم انظر إليها في بيت المتنبي من الطويل: لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. وهذا باب واسع فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعملا كلماً بأعيانها. ثم ترى هذا قد فرع السماك وترى ذاك قد لصق بالحضيض. فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ وإذا استحقت المزية والشرف واستحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم لما اختلف بها الحال ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً. ولم تر قولاً يضطرب على قائله حتى لا يدري كيف يعبر وكيف يورد ويصدر كهذا القول. بل إن أردت الحق فإنه من جنس الشيء يجري به الرجل لسانه ويطلقه. فإذا فتش نفسه وجدها تعلم بطلانه وتنطوي على خلافه. ذاك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد ولا يكون له صورة في فؤاد.
ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل: الفرق بين قولنا: حروف منظومة وكلم منظومة. وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد. وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتضي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس. فهو إذاً نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق. وكذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصح. والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانباً. وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاط أن تنظم على وجه دون وجه. ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء. ولا يتصور أن يجب فيها ترتيب ونظم. ولو حفظت صبياً شطر كتاب العين أو الجمهرة من غير أن تفسر له شيئاً منه وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيئتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور لرأيته ولا يخطر ببال أن من شأنه أن يؤخر لفظاً ويقدم آخر. بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوز. اللهم إلا أن تسومه أنت أن يأتي بها على حروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب. ودليل آخر وهو أنه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساساً واحداً ولا يعرف وأوضح من هذا كله وهو أن النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس أبالمعاني أم بالألفاظ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئاً. وإنما تصنع في غيره لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجر وهو من الإحالة المفرطة. فإن قيل: النظم موجود في الألفاظ على كل حال ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص قيل: إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جذعة أبداً والذي يحلها أن تنظر: أتتصور أن تكون معتبراً مفكراً في حال اللفظ مع اللفظ متى تضعه بجنبه أو قبله وأن تقول: هذه اللفظة إنما صلحت هاهنا لكونها على صفة كذا. أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت هاهنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها فإن تصورت الأول فقل ما شئت. واعلم أن كل ما ذكرناه باطل. وإن لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعن نفسك بالأضاليل ودع النظر إلى ظواهر الأمور. واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. وكيف تكون مفكراً في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا ومما يلبس على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال: هذا كلام قد نظمت معانيه. فالعرف كأنه لم يجر بذلك إلا أنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له وذلك قولهم: إنه يرتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض. كما يقولون: يرتب الفروع على الأصول ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير بالنظير. وإذا كنت تعلم أنهم استعاروا النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا له النظم وكان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل يرجع إلى وأعلم أن من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حداً وتجعل النكت التي ذكرتها في على ذكر منك أبداً فإنها عمد وأصول في هذا الباب. إذ أنت مكنتها في نفسك وجدت الشبه تنزاح عنك والشكوك تنتفي عن قلبك ولا سيما ما ذكرت من أنه لا يتصور تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه. ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك. فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها. وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتجج إلى تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق.
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب تلك. هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلاً لفعل أو مفعولاً أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تتبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالاً أو تمييزاً أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفياً أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا معنى أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القياس. وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب النطق فيها ترتيب ونظم وأن يجعل لها أمكنة ومنازل وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك. والله الموفق للصواب.
وهذه شبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير روية. وهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان كالذي أنشده الجاحظ من قول ساعر من السريع: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر وقول ابن يسير من الخفيف: لا أذيل الآمال بعدك إني بعدها بالأمال جد بخيل كم لها موقفاً بباب صديق رجعت من نداه بالتعطيل لم يضرها والحمد لله شيء وانثنت نحو عزف نفس ذهول قال الجاحظ: فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ بعض. ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه كالذي مضى. ومنه ما هو أخف منه كقول أبي تمام من الطويل: كريم متى أمدحه أمدحه والورى جميعاً ومهما لمته لمته وحدي ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان إلا أنه لا يبلغ أن يعاب به صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه. ويزعم أن الكلام إذا سلم من ذلك وصفا من شوبه كان الفصيح المشاد به والمشار إليه. وأن الصفاء أيضاً يكون على مراتب يعلو بعضها بعضاً وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز. والذي يبطل هذه الشبهة إن ذهب إليها ذاهب أنا إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة ومن أن تكون نظيرة لها. وإذا فعلنا ذلك لم نخل في أحد أمرين: إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعرج على غيره وإما أن نجعله أحد ما نفاضل به ووجهاً من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام. فإن أخذنا بالأول لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه حتى لا يكون الإعجاز إلا به. وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة لأنه يؤدي إلى أن لا يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وتصحيح الأقسام وحسن الترتيب والنظام والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل والإجمال ثم التفصيل ووضع الفصل والوصل موضعهما وتوفية الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما مدخل فيما له كان القرآن معجزاً حتى ندعي أنه لم يكن معجزاً من حيث هو بليغ ولا من حيث هو قول فصل وكلام شريف النظم بديع التأليف وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم الحروف. وإن أخذنا بالثاني وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجهاً من وجوه الفضيلة وداخلاً في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان وأن تكون نظيرة لهما وفي عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك مما ينبىء عن شرف النظم وعن المزيا التي شرحت لك أمرها وأعلمتك جنسها أو يجعلها اسماً مشتركاً يقع تارة لما تقع له وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على اللسان. وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصدده. وإن تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو فيما له كان القرآن معجزاً كان الوجه أن يقال له: إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هاهنا نظم للألفاظ وترتيب لا على نسق المعاني ولا على وجه يقصد به الفائدة ثم يكون مع ذلك معجزاً وكفى به فساداً. فإن قال قائل: إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزاً حتى يكون اللفظ ذلك دالا وذاك أنه تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني. كما أنه إنما تصعب مراعاة السجع والوزن ويصعب كذلك التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى قيل له: فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسألتك وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقاً وتضع له علة غير ما يعرفه الناس وتدعي أن ترتيب المعاني سهل وأن تفاضل الناس في ذلك إلى حد وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخي في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم وهذا منك وهم وذلك أنا لا نعلم تعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجده في بيت أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى وبيت ابن يسير: وانثنت نحو عزف نفس ذهول وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ونحو ذلك مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض. فقولنا: أطال الله بقاءك وأدام عزك وأتم نعمته عليك وزاد في إحسانه عندك لفظ سليم مما يكد اللسان وليس في حروفه استكراه. وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه لأنه إنما هو شيء يعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل. فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك. هذا والمتعلل بمثل ما ذكرت من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزاً بعد أن يكون اللفظ دالاً لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني إذا تأملت يذهب إلى شيء ظريف وهو أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى وذلك محال لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ فصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ وذاك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المسجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أردافاً لها فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب أو دخلت في ضرب من المجاز أو أخذت في نوع من الاتساع وبعد أن تلطفت على الجملة ضرباً من التلطف. وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنى وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصلته احتجت إلى أن تطلب اللفظ على حدة وذلك محال. هذا وإذا توهم متوهم أنا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ وأن من شأن الطلب أن يكون هناك فإن الذي يتوهم أنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة. وإذا كان لك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال حروف في النفس ثم تخفى علينا مواقعها في النطق حتى يحتاج في ذلك إلى فكر وروية وذلك ما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه. وإذا بطل أن يكون ترتيب الففظ مطلوباً بحال ولم يكن المطلوب أبداً إلا ترتيب معاني وكان معول هذا المخالف على ذلك فقد اضمحل كلامه وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزية والإعجاز حول اللفظ ورام أن يجعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الحيرة والخروج عن فاسد من القول إلى مثله. والله الموفق للصواب. فإن قيل: إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على معنى فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى قال: معنى فصيح وكلام فصيح المعنى قيل: إنما اختصت الفصاحة باللفظ وكانت من صفته من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثها وإذا كانت لكون اللفظ دالاً استحال أن يوصف بها المعنى كما يستحيل أن يوصف المعنى بأنه دال مثلاً فاعرفه. فإن قيل: فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ فقالوا: معنى لطيف ولفظ شريف وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم وحتى قال أهل النظر: إن المعانى لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ. فأطلقوا كما ترى كلاماً يوهم كل من يسمعه أن المزية في حاق اللفظ. قيل له: لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في نطقه تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف الترتيب. ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض وكشف عن المراد كقولهم: لفظ متمكن يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه. ولفظ قلق ناب يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح له فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مستعار له من معناه. وأنهم نحلوه إياه بسبب مضمونه ومؤداه. هذا ومن تعلق بهذا وشبهه واعترضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من هاهنا وثم. ومن كان هذا سبيله فليس له دواء سوى السكوت عنه وتركه وما يختاره لنفسه من سوء النظر وقلة التدبر. قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعمل رويتك وتراجع عقلك وتستنجد في الجملة فهمك. وبلغ القول في ذلك أقصاه وانتهى إلى مداه. وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض وإنه لمرام صعب ومطلب عسير. ولولا أنه على ذلك لما وجدت الناس بين منكر له من أصله ومتخيل له على غير وجهه ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة ولا تملك فيه إلا الإشارة وأن طريق التعليم إليه مسدود وباب التفهيم دونه مغلق وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرز من الضمير وأن تدين للتبيين والتصوير وأن ترى سافرة لا نقاب عليها ونادية لا حجاب دونها وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير أو يضرب مثلاً ينبىء عن حسن قد عرفه على الجملة وفضيلة قد أحسها من غير أن يتبع ذلك بياناً ويقيم عليه برهاناً ويذكر له علة ويورد فيه حجة وأنا أنزل لك القول في ذلك وأدرجه شيئاً فشيئاً وأستعين بالله تعالى عليه وأسأله التوفيق.
اعلم أن لهذا الضرب اتساعاً وتفنناً لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومىء به إليه ويجعله دليلاً عليه مثال ذلك قولهم: هو طويل النجاد يريدون طويل القامة وكثير رماد القدر يعنون كثير القرى. وفي المرأة: نؤوم الضحى والمراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود وأن يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد وإذا كثر القرى كثر رماد القدر وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى. وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز. والكلام في ذلك يطول. وقد ذكرت ما هو الصحيح من ذلك في موضع أخر. وأنا أقتصر هاهنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر. والاسم والشهرة فيه لشيئين: الاستعارة والتمثيل. وإنما يكون التمثيل مجازاً إذا جاء على حد الاستعارة. فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه تريد أن تقول: رأيت رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء فتدع ذلك وتقول: رأيت أسداً. وضرب آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قوله: من الكامل: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرون الاستعارة فليسا سواء وذاك أنك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به. وفي الثاني تجعل للشيء الشيء ليس له. تفسير هذا أنك إذا قلت: رأيت أسداً فقد ادعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه ولا يكون الإنسان أسداً. وإذا قلت: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها فقد ادعيت أن للشمال يداً. ومعلوم أنه لا يكون للريح يد. وهاهنا أصل يجب ضبطه وهو أن جعل المشبه المشبه به على ضربين: أحدهما تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الشيئين ولا تذكره بوجه من الوجوه كقولك: رأيت أسداً. والثاني أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته. وذلك حيث تجري اسم المشبه به صراحة على المشبه فتقول: زيد أسد وزيد هو الأسد. أو نجيء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك: إن لقيته لقيت به أسداً وإن لقيته ليلقينك منه الأسد. فأنت في هذا كله تعمل في إثبات كونه أسداً أو الأسد وتضع كلامك له. وأما في الأول فتخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقرير. والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب أعني ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته أنه تشبيه على حد المبالغة ويقتصر على هذا القدر ولا يسمى استعارة. وأما التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حد الاستعارة فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فالأصل في هذا: أراك في ترددك كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى. ثم اختصر الكلام وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة كما كان الأصل في قولك: رأيت أسداً: رأيت رجلاً كالأسد ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة. وكذلك تقول للرجل يعمل غير معمل: أراك تنفخ في غير فحم وتخط على الماء فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفخ ويخط والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك. وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع منه: ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد. فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فتل في ذروة وغارب. والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير الصعب فيحكه ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس. وهو في المعنى نظير قولهم: فلان يقرد فلاناً يعنى به أنه يتلطف له فعل الرجل ينزع القراد من البعير ليلذه ذلك فيسكن ويثبت في مكانه حتى يتمكن من أخذه. وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه التمثيل ثم لم يفصحوا بذلك وأخرجوا اللفظ مخرجه إذا لم يريدوا تمثيلاً. قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح وأن للاستعارة مزية وفضلاً وأن المجاز أبداً أبلغ من الحقيقة. إلا أن ذلك وإن كان معلوماً على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسألة فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت: هو طويل النجاد وهو جم الرماد كان أبهى لمعناك وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد. وكذا إذا قلت: رأيت أسداً كان لكلامك مزية لا تكون إذا قلت: رأيت رجلاً هو في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش وأشباه ذلك وإذا قلت: بلغني أنك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى كان أوقع من صريحه الذي هو قولك بلغني أنك تتردد في أمرك وأنك في ذلك كمن يقول: أخرج ولا أخرج. فيقدم رجلاً ويؤخر أخرى. ونقطع على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه فإنما تسكن أنفسنا تمام السكون عرفنا السبب في ذلك والعلة ولم كان كذلك وهيأنا له عبارة تفهم عنا من نريد إفهامه وهذا هو قول في ذلك. اعلم أن سبيلك أولاً أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره والمبالغة التي تدعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها. تفسير هذا أن ليس المعنى إذا قلنا: الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد. فليست المزية في قولهم: جم الرماد أنه دل على قرى أكثر بل المعنى أنك أثبت له القرى الكثير من وجه وهو أبلغ. وأوجبته إيجاباً أشد وادعيته دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق. وكذلك ليست المزية التي تراها لقولك: رأيت أسداً على قولك: " رأيت رجلاً لا يتميز من الأسد في شجاعته وجرأته أنك قد أفدت بالأول زيادة في مساواته الأسد بل أنك أفدت تأكيداً وتشديداً وقوة في إثباتك له هذه المساواة وفي تقريرك لها. فليس تأثير الاستعارة إذاً في ذات المعنى وحقيقته بل في إيجابه والحكم به. وهكذا قياس التمثيل ترى المزية أبداً في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه. فأذا سمعتهم يقولون: إن من شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلاً فضلاً وتوجب لها شرفاً وأن تفخمها في نفوس السامعين وترفع أقدارها عند مخاطبين فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له ويخبر بها عنه. هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه أبداً وأن يعلم أن ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل ولا هي منا بسبيل وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب. وإذ قد عرفت مكان هذا المزية والمبالغة التي لاتزال تسمع بها وأنها في الإثبات دون المثبت فإن لها في كل واحد من هذه الأجناس سبباً وعلة. أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإيجابها بما هو شاهد في جودها آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها ساذجاً غفلاً وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط. وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت: رأيت أسداً كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده. وذلك أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة وكالمستحيل أو الممتنع أن يعرى عنها. وإذا صرحت بالتشبيه فقلت: رأيت رجلاً كالأسد كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون ولم يكن من حديث الوجوب في شيء. وحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء فإنك إذا قلت: أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى فأوجبت له الصورة التي يقطع معها بالتحير والتردد كان أبلغ لا محالة من أن تجري على الظاهر. فتقول: قد جعلت تتردد في أمرك فأنت كمن يقول: أخرج ولا أخرج فيقدم رجلاً ويؤخر أخرى. اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشديد. أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامي المبتذل كقولنا: رأيت أسداً ووردت بحراً ولقيت بحراً والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله من الطويل: وسالت بأعناق المطي الأباطح أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة وكانت سرعة في لين وسلاسة كأنه كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وغلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر من البسيط: سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير أراد أنه مطاع في الحي وأنهم يسرعون إلى نصرته وأنه لا يدعوهم لحرب أو نازل خطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجيء من هاهنا وهاهنا وتنصب من هذا المسيل وذلك حتى يغص بها الوادي ويطفح منها. ومن بديع الاستعارة ونادرها إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له وأنه مؤدب وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه من الكامل: عودته فيما أزور حبائبي إهماله وكذاك كل مخاطر وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر فالغرابة هاهنا في الشبه نفسه وفي أن استدراك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس سرج كالهيئة في موضع الثوب من ركبة المحتبي. وليست الغرابة في قوله: وسالت بأعناق المطي الأباطح على هذه الجملة وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطي في سرعة سيرها وسهولته الماء يجري في الأبطح فإن هذا شبه معروف ظاهر. ولكن الدقة واللطف في خصوصية أفادها بأن جعل سال فعلاً للأباطح ثم عداه بالباء ثم بأن أدخل الأعناق في البيت فقال: بأعناق المطي ولم يقل بالمطي ولو قال: سالت المطي في الأباطح لم يكن شيئاً. وكذلك الغرابة في البيت الآخر ليس في مطلق معنى سال ولكن في تعديته على والباء وبأن جعله فعلاً لقوله: شعاب الحي. ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا حسن. وهذا موضع يحق الكلام فيه. اليوم يومان مذ غيبت عن بصري نفسي فداؤك ما ذنبي فأعتذر أمسي وأصبح لا ألقاك واحزنا لقد تأنق في مكروهي القدر سوار بن المضرب وهو لطيف جداً من الوافر: بعرض تنوفة للريح فيها نسيم لا يروع الترب وان بعض الأعراب من الكامل: ولرب خصم جاهدين ذوي شذاً تقذي عيونهم بهتر هاتر لد ظأرتهم على ما ساءهم وخسأت باطلهم بحق ظاهر المقصود: لفظة خسأت. ابن المعتز من الرجز: حتى إذا ما عرف الصيد الضار وأذن الصبح لنا في الإبصار المعنى: حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئاً لما كان تعذر الإبصار منعاً من الليل جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذناً من الصبح. وله من مجزوء الوافر: بخيل قد بليت به يكد الوعد بالحجج وله من الطويل: ومما هو في غاية الحسن وهو من الفن الأول قول الشاعر أنشده الجاحظ: لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ماطاح طائح يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا يدفع الموت النفوس الشحائح قال: وإليه ذهب بشار في قوله من الرجز: وصاحب كالدمل الممد حملته في رقعة من جلدي ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة الجسر في قول أبي تمام من البسيط: لا يطمع المرء أن يجتاب لجته بالقول ما لم يكن جسراً له العمل وقوله من البسيط: بصرت بالراحة العظمى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب فترى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول. ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي من البسيط: قولي: نعم ونعم إن قلت واجبة قالت: عسى وعسى جسر إلى نعم فترى لها لطفاً وخلابة وحسناً ليس الفضل فيه بقليل. ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصداً إلى أن يلحق الشكل بالشكل وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد. مثاله قول امرئ القيس من الطويل: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل لما جعل لليل صلباً قد تمطى به ثنى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها الصلب وثلث فجعل له كلكلاً قد ناء به. فاستوفى له جملة أركان الشخص وراعى ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى ما خلفه وإذا رفع البصر ومدده في عرض الجو.
|